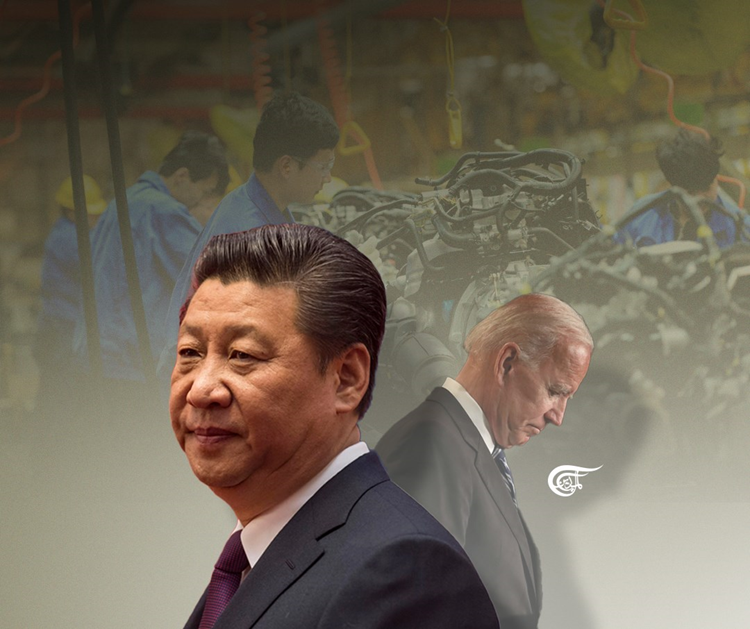الصباح اليمني_مساحة حرة|
بات واضحاً أن حقبة الهيمنة الأميركية المطلقة على النظام الدولي لم تدم أكثر من عقدين على أحسن تقدير، لم يجرؤ أحد خلالهما على تحدّي الولايات المتحدة، لكنّ هذا الوضع بدأ يتغير سريعاً.
في بداية التسعينيات من القرن الماضي، تفكك حلف وارسو، وانهارت منظومة الدول الاشتراكية، قبل أن يختفي الاتحاد السوفياتي نفسه من خريطة العالم لتحلّ محلّه روسيا الاتحادية. حينها، ظنّت الولايات المتحدة أن بإمكانها التربّع وحدها على قمة النظام الدولي، والهيمنة عليه لفترة طويلة قادمة، ثم راحت تروّج بإصرار لرؤية جديدة مفادها أن النظامين الرأسمالي والليبرالي حققا انتصاراً نهائياً، وأن القرن الواحد والعشرين سيصبح قرناً أميركياً بامتياز.
ولأنه لم يكن بوسع أحد تحدي طموحات القوة الأميركية، خصوصاً أن الهوة التي كانت تفصل بينها وبين الدول التالية لها على سلم القوة الشاملة بدت شاسعة في ذلك الوقت، فقد كان من الطبيعي أن يظنّ كثيرون أن هذه الهوة باتت غير قابلة للجسر.
ويكفي أن نتذكر هنا أن حجم الإنفاق العسكري الأميركي في ذلك الوقت كان قد تجاوز مجموع الإنفاق العسكري للدول العشر التالية لها.
اليوم، تبدو الصورة مختلفة كلياً؛ فقد بات واضحاً الآن أن حقبة الهيمنة الأميركية المطلقة على النظام الدولي لم تدم أكثر من عقدين على أحسن تقدير، أي طوال العقد الأخير من القرن العشرين وحتى قرب نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، لم يجرؤ أحد على تحدي الولايات المتحدة في أي منطقة من العالم، أو حتى مجرد استخدام الفيتو ضد إرادتها في مجلس الأمن.
لكنّ هذا الوضع بدأ يتغير سريعاً، خاصة بعد أن بدأت روسيا تتمرد على قيود كثيرة كانت قد فرضت عليها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي، ولم تعد تتردّد في استخدام كل الوسائل المتاحة لديها للدفاع عن مصالحها القومية، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية ضد الإرادة الأميركية، وهو ما بدا واضحاً في إبان الأزمة التي اندلعت في جورجيا عام 2008، والأزمة التي اندلعت في أوكرانيا عام 2014، ليبلغ هذا التحدي مداه في شباط/فبراير من العام الحالي، حين أقدمت روسيا على عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف “الناتو”، وسلخ عدد من الأقاليم التي تقطنها أغلبية روسية وضمّها إلى أراضيها.
ومع ذلك، تعتقد الولايات المتحدة أن روسيا لا تمثل تهديداً حقيقياً لمصالحها أو لمكانتها، لأنها لا تملك من عناصر القوة الشاملة ما يؤهّلها لمنافستها في قيادة النظام الدولي، ولاعتقادها بأن الصين أصبحت الدولة الوحيدة القادرة على ذلك، بل والراغبة في تحقيقه (راجع مقال: “روسيا والصين في إستراتيجية الأمن القومي الأميركي”).
حين كان المعسكر الشرقي يتهاوى في بداية تسعينيات القرن الماضي، لم يكن بمقدور أحد، بما في ذلك مراكز البحث والتفكير الأميركية، التنبؤ بأن الصين يمكن أن تصعد بمثل هذه السرعة المذهلة نحو قمة النظام الدولي.
ففي عام 1990، كان إجمالي الناتج المحلي في الصين، مقوّماً بالأسعار الجارية، 360 مليار دولار فقط، أي نحو 6% فقط من إجمالي الناتج المحلي الأميركي الذي بلغ في ذلك العام 5960 مليار دولار (نحو 6 تريليون دولار).
أما في عام 2020، فقد وصل هذا الإجمالي إلى 14.7 تريليون، وهو ما يمثل نحو 67% من إجمالي الناتج الأميركي الذي بلغ في ذلك العام 20919 مليار دولار (نحو 21 تريليون دولار).
وربما تصبح الصورة أكثر وضوحاً إذا أخذنا في الاعتبار تطور هذا الناتج المحلي مقوّماً بالقوة الشرائية. ففي عام 1990، قوّم هذا الناتج في الصين بما يعادل 1115 مليار دولار (نحو 1.1 تريليون)، وهو ما يمثل نحو 20% من إجمالي الناتج الأميركي، البالغ حينئذ 5693 مليار (نحو6 تريليون دولار).
أما في عام 2020، فقد بلغ 24277 مليار دولار (نحو 24.2 تريليون دولار)، فيما لم يتجاوز الناتج المحلي الأميركي في العام نفسه 20963 مليار (نحو 21 تريليون دولار).
معنى ذلك أن الوضع انعكس كلياً، إذ أصبح إجمالي الناتج المحلي الأميركي، مقوّماً بالقوة الشرائية، يمثل 75% فقط من الناتج المحلي الصيني. أما إذا فضّلنا الاستعانة بمؤشر آخر، وهو متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، فسوف نحصل على نتائج لا تقل إثارة.
ففي عام 1990، كان متوسط نصيب الفرد الصيني من الناتج المحلي يساوي 983 دولاراً فقط، أي أقل من 1000 دولار سنوياً، فيما كان متوسط نصيب الفرد الأميركي يساوي 23889 دولاراً سنوياً (اي نحو 24 ضعفاً).
وفي عام 2020، أصبح هذا المتوسط 17312 دولاراً للفرد الصيني، في مقابل 63544 للفرد الأميركي (أي نحو أربعة أضعاف فقط). معنى ذلك أن متوسط نصيب الفرد الصيني من الدخل القومي تضاعف 18 مرة خلال ثلاثين عاماً، فيما لم يتضاعف متوسط نصيب الفرد الأميركي من الدخل القومي خلال الفترة نفسها سوى 3 مرات فقط تقريباً. وليس هناك من تفسير لهذه الأرقام المذهلة سوى تباين معدلات النمو الاقتصادي، والتي تراوحت خلال الفترة من 1990-2020، بالنسبة إلى الصين، بين أقل قليلاً من 3% في حدّها الأدنى و14% في حدّها الأقصى، أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فقد تراوحت النسبة في الفترة نفسها بين (-3%) في حدّها الأدنى ونحو 5% في حدّها الأقصى.
ليس معنى هذا أن الصين أصبحت أقوى من الولايات المتحدة، فلا شك في أن موازين القوة الشاملة، لا سيما في المجال العسكري وفي بعض المجالات الصناعية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، ما زالت تميل بوضوح لمصلحة الولايات المتحدة. لكنّ مستوى التقدم التكنولوجي الذي حققته الصين في مختلف المجالات وصل إلى حدّ يجعل من نمو الاقتصاد الصيني مسألة غير قابلة للارتداد، ويساعده على لعب دور القاطرة في تطوير الاقتصاد ككل، وربما يمكنه من تحقيق السبق على الاقتصاد الأميركي في المدى المنظور، خصوصاً إذا تمكنت الصين من تحقيق معدلات نمو تقترب من تلك التي حققتها خلال الأعوام الثلاثين السابقة.
وفي تقديري أن الصين تمتلك ميزة إستراتيجية كبرى تجعل من قدرتها على تحقيق السبق على الولايات المتحدة مسألة وقت، وأقصد بذلك حجم السكان، وبالتالي حجم السوق الداخلي. فعدد سكان الصين يبلغ الآن ما يقرب من 1500 مليون نسمة، مقابل نحو 330 مليون نسمة فقط للولايات المتحدة، أي ما يعادل أكثر من 4 أضعاف. فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن الصين تمكنت مؤخراً من تحقيق السبق على الولايات المتحدة في عدد من المجالات الهامة، خاصة في مجال الاقتصاد الرقمي وتجهيزات الاتصالات، ما دفع ترامب إلى اللجوء إلى قانون الطوارئ الاقتصادي الدولي لاتخاذ قرار يستهدف “حماية المعلومات وتقنية الاتصالات وسلاسل تزويد الخدمات”، لتبيّن لنا حجم القلق الذي يسود أعلى مراكز صنع القرار الأميركي، وتزايد الشعور بالخوف من احتمال تمكّن الصين من التفوّق على الولايات المتحدة في المستقبل المنظور، وإزاحتها من موقع الصدارة أو الهيمنة المنفردة على النظام الدولي.
ومن المعروف أن لدى الصين، بالإضافة إلى ما تملكه من قدرات مالية واستثمارية هائلة، مشروعاً إنمائياً كونياً ضخماً، هو مشروع “الحزام والطريق” يسمح لها بمدّ نفوذها إلى مختلف دول العالم، وتحديداً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وإضعاف النفوذ الأميركي فيها أو زحزحته منها، وقد بدأت تطوير قدراتها العسكرية، لا سيما البحرية؛ لمواكبة النمو المتراكم لتجارتها واستثماراتها الخارجية.
في سياق كهذا، من الطبيعي أن تسعى الولايات المتحدة الأميركية، وبكل الوسائل المتاحة والممكنة، لعرقلة الصعود الصيني نحو القمة، فبالإضافة إلى السياسة الحمائية التي انتهجتها إدارة ترامب، بدأت إدارة بايدن تتحرك على أكثر من جبهة. فهي، من ناحية، تحاول تطويق الصين من خلال دعم علاقاتها بالدول الحليفة، لا سيما الدول التي تستطيع أن تلعب دوراً فاعلاً في مقاومة النفوذ الصيني في المناطق المطلة على بحر الصين وعلى المحيطين الهادئ والهندي، خاصة مع كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وإندونيسيا.
وهي، من ناحية ثانية، تتبنى سياسة تستهدف عرقلة المساعي الرامية إلى بسط سيادة الصين على جزيرة تايوان.
ومع أن السياسة المعلنة للولايات المتحدة تؤكد التزامها بمبدأ “الصين الواحدة” فإن سياستها الفعلية تسعى بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك إبرام صفقات سلاح متتالية مع تايوان، للحيلولة دون تمكين الصين من تحقيق هذا الهدف.
وهي، من ناحية ثالثة، تحاول قطع الطريق على مبادرة “الحزام والطريق”، وذلك من خلال الانفتاح أكثر على دول العالم الثالث، والعمل على زيادة استثماراتها فيها. ومن الواضح أن المؤتمر الأميركي-الأفريقي الذي يعقد حالياً في واشنطن يندرج في هذا الإطار، وهو ثاني مؤتمر من نوعه بعد المؤتمر الذي نظمته إدارة أوباما عام 2014.
تمارس الصين في مواجهة الولايات المتحدة سياسة النفس الطويل أو “الصبر الاستراتيجي”. ولأنها على يقين بأن الوقت يلعب لمصلحتها، فلن تقوم بأي مبادرات قد توقعها في حبائل الاستفزازات الأميركية.
لذا، يتوقع أن تستمر الصين في انتهاج سياسة براغماتية تساعدها على العمل في هدوء تام لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في مختلف أنحاء العالم، لاعتقادها أن هذا هو السبيل الوحيد الذي يسمح لها بمدّ نفوذها إلى كل مكان، ويرجح أن تنجح في إفشال كل المحاولات الأميركية الرامية إلى عرقلة صعودها المتواصل نحو قمة النظام الدولي.
خليك معناالمصدر: الميادين نت