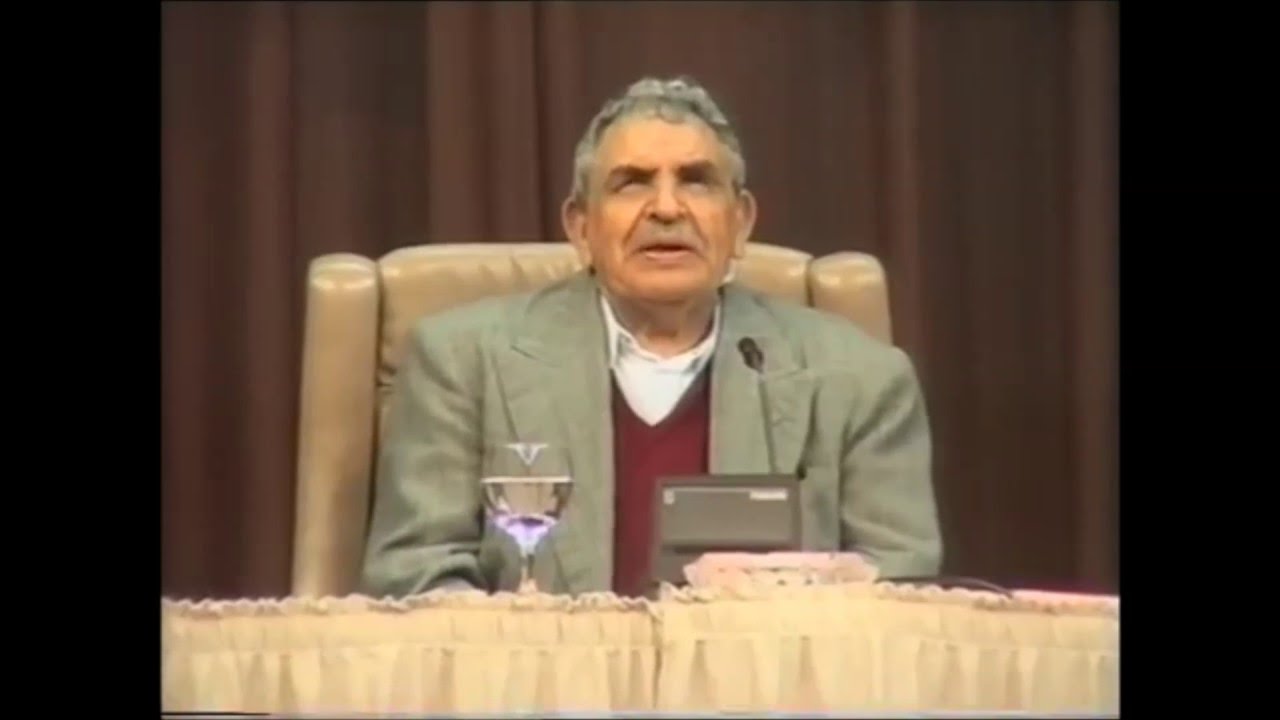الصباح اليمني_ثقافة وهوية|
كتب عبدالله البردّوني قصيدته الشهيرة “ربيعية الشتاء” خلال شهري مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران 1990، أي أنها أخذت فترة زمنية استثنائية دون سائر قصائده، بالتزامن مع حدث تاريخيّ انشغل اليمنيون جميعًا بالاحتفال والفرحة به والانسياق العاطفي معه، دون التفكير المنطقي والعقلاني اللازم لرؤية مقدماته بوضوح، وقراءته بمنطق طبيعي يربط بين المقدمة والنتيجة، وبين الأسلوب وطبيعة وشكل المنتج النهائي، وهو ما تفرغ له عبدالله البردّوني وحده، بطبيعته المغايرة والمتفردة.
هو لم يعترض على الهدف ولم يقلل من أهمية الحدث، بل اختلف مع صنّاعه حول العمليات التي جرى إنتاج الحدث عبرها لتقود الجنين إلى ولادة مشوهة لم تستكمل فترة الحمل؛ رأى أنها غامضة ومستعجلة بما يغاير المنطق ولا يتناسب مع أهمية الغاية، ولا مع تاريخ العلاقات العدائية، التي ربطت شريكي “الوحدة” في الشطرين، كنظامين مختلفين خاضَا حربين مباشرتين وصراعات كثيرة ومستمرة لعقود. وتسمية القصيدة ذاتها “ربيعية الشتاء” تشير إلى أن زهرة “الوحدة” كما لو أنها تفتحت في فصل الشتاء غير الملائم لولادة وحياة الزهور، فلا تعيش فيه غير الأشواك، ولم تنتظر الزهرة المنتظرة المناخ الطبيعي اللازم لبقائها وحيويتها في فصل الربيع كما كان يجب.
هذا الذي سمّيته منزلي كان انتظارًا قبلَ أن تدخلي
كان سؤالَ القلبِ عن قلبه يشتاقَ عن قلبيه أن تسألي
أن ترجعي مثل الربيع الذي يغيب في الأعواد كي ينجلي.
الجميع كان ينتظر دخول “الوحدة” (العروس) منزل اليمنيين المعلوم والمستقر، والمنزل وصف أعلى من البيت، فالأخير سكن مادي، أما المنزل ففيه العاطفة والحنين والبناء أيضًا، لكنه كان يؤمل أن تسأل عنه كقلبين بما يميز كل منهما أولًا، ثم التعامل معهما كقلب واحد بعد تجاوز مرحلة التمايز للقلبين المتحدين في القلب الجديد، فالقفز على خصائص كل قلب إلى ضمهما في قلب واحد، خالف المأمول من منزل القلبين. وفي هذه الحالة، كان يأمل أن تعود “الوحدة” إلى كُمونها حتى تكتمل شروط ظهورها، كما يكمن الربيع في عود الشجرة حين تتساقط أوراقها، فيحتفظ بخضرته وأزهاره في صلب العود حتى يأتي موسمه، فيظهر كعملية إحياء للزهور والأشجار والبراعم التي تثمر في موعدها الطبيعي. وقد أُعلِنت “الوحدة” زمنيًّا في شهر مايو/ أيار؛ أي في ذروة اكتمال الربيع، لكنه من حيث الظروف والبيئة كان شتاء قاتلًا للخضرة والزهور.
رأى البردّوني أن قدوم “”الوحدة”” مبكرة قبل أن تستكمل شروطها، لن يحقق أهدافها في زمن التحولات العالمية المذهلة التي هدمت جدار برلين، وفككت إمبراطورية الاتحاد السوفيتي، فنقلت العالم بذهول من قطبين عالميين إلى قطب واحد متفرد، هو المعسكر الغربي بقيادة واشنطن:
أقَبْلَ سُكْرِ الوعد، قالوا صَحَت؟ أيُّ هوًى أرغَى بها: عجِّلِي؟
هذا زمــــــــــــانٌ مذهلٌ ذاهــــــــــــــلٌ عنه، فمن حاولتِ أن تُذهلي؟
ذا جمر صنعا، خُفتُ إذْ أحرقوا فيه “بخور الشيخ”، أن تسعلي.
فكيف يصحى المرء قبل أن يسكر! وهذا معاكس لمراحل التطور الطبيعي والتغير المنطقي؛ إذ يجب أن يكون السُّكر أولًا ثم الصحو منه نتيجة له، أما غير ذلك فيجعل الأشياء تؤدي وظيفة عكس المرغوب منها. فالبخور العدني الذي تشتهر به منطقة “الشيخ عثمان”، طيب الرائحة، لكنه تحول بسوء التقدير والإحراق المستعجل في جمر صنعاء إلى مصدر للسعال، كأي دخان ضارّ، فلم ينشر عبقه الطيّب في الأرجاء كما هي وظيفته وهدف استخدامه المتعارف عليه؛
أقول: ماذا؟ صاح من لا أرى: عليك من نصفيك أن ترحلي
من مكتب التأجيل قالوا: ثِبي أنهي كتابَ الأمس؟ لا، أجِّلي
لا تحمــــــــــــــــلي أي كتاب ولا دواة “جيــــفارا” ولا “الزِّركـــلي”
ماذا ألاقي يا “بن علوان” قل يا “عيدروس” احمل معي مثقلي.
أدار البردوني حواريته في القصيدة، لتبدو “”الوحدة”” كائنًا حيًّا ناطقًا يحاور ويتساءل، ويفرح ويتذمر، ويطالب ويأمر، فهي تقول: “صاح من لا أرى”، أي أن هناك دوافع غير منطقية ولا معروفة لتعجيل “الوحدة”، وطرف غير معلوم هو من أملى الأوامر بصوت مرتفع لترحل “الوحدة” من نصفيها، لكنه لم يحدد محطة مشتركة لها، للوصول بنصفيها إلى صيغة جسد واحد مكتمل. فقد غادرت النصفين دون أن تدمجهما بذوبان كامل لخلق عنصر كيميائي جديد منهما معًا، كما أن مشاكل الماضي لم تحسم قبل “الوحدة”، بل أراد الصائح بها أن تحملها معها، وتؤجل البتّ فيها لتظهر مثيرة للمشاكل والصراعات مستقبلًا، فعليها ترك موروث اليسار التقدمي الذي مثله نظام عدن الاشتراكي برمزية “جيفارا” الثورية في العالم، وأيضًا ترك الموروث الشعبي التقليدي لـ”الزركلي” الذي يمثله نظام صنعاء الشعبوي غير المؤدلج والموصوف بـ”الرجعية” مقابل تقدمية نظام عدن. وقد أشار إلى هذه الثنائية المتناقضة أيضًا في قصيدة “ثوار والذين كانوا”:
وافقتم اليوم ألّا يدعي أحدٌ تعاكسًا بين “باتيستا” و”جيفارا”
فرمزية “باتيستا” المتناقضة مع رمزية من كافح ضدها وثار عليها “جيفارا”، تشير إلى استحالة توافق الشخصيتين بمجرد أن تتوافق على التخلي عن الملامح المميزة لكلّ منها، كشطري اليمن عند تحقيق “الوحدة”، ولم ترسم بعد ملامح جديدة تميز عهد مولودها الجديد. وفي السياق ذاته، لم يتعاون “ابن علوان” و”العيدروس” (شخصيتان صوفيتان شهيرتان في اليمن، الأول في منطقة “يفرس” بتعز” والثاني في “الشيخ عثمان” بعدن)، في حمل أثقال واستحقاقات “الوحدة” التي تحتاج لمعجزة كما يرمز إليها المقصود عند سكان الشطرين لطلب العون من “الأولياء الصالحين”. فالشماليون كانوا يقصدون ضريح الصوفيّ الأشهر “أحمد بن علوان”، لتحقيق المعجزات بشفاء المستعصي من الأمراض وتحقيق بعيد المنال من الآمال، كما هو ضريح الوليّ الصوفيّ “العيدروس” عند الجنوبيين، فقد ظلّ نطاق اختصاص كلٍّ منهما، كما هو، شعبيًّا.
كما أن الشك في مستقبل الطريق، الذي سلكه الشطران في مايو/ أيار 1990، ظل قائمًا، لتلجأ “الوحدة” إلى سؤال العرّافين عن طالعها، واللجوء إلى العرافين يعني العجز عن سؤال المختصين أو رفضهم الرد، أو خروج الظاهرة عن منطق العلوم القابلة للقياس والتخطيط:
سألت ذات الودع، ما طالعي؟ أفضت بردَّيـــــن: عليَّ وليْ
لأي أزواجي جنى عشـــــــــرتي؟ خذي سواهم قبل أن تحملي
وكانت إجابة السؤال أنّ هناك احتمالين لمستقبل “الوحدة” وضعهما البردوني على لسان العرافة “ذات الودع” أمامها: أحدهما عليها، وهو مقدم على الآخر الذي (لها)؛ أي أن المخاطر هي الاحتمال الأرجح؛ لأن “الوحدة” مقترنة بزوجين هما شريكا “الوحدة” كحزبين (المؤتمر الشعبي، والاشتراكي) أو كفردين (علي عبدالله صالح، وعلي سالم البِيض)، وهي محتارة بينهما لتتساءل عن الأحق منهما بجني ثمارها، وكانت الإجابة هنا واضحة:
“خذي سواهم قبل أن تحملي”، أي إن استمرار “الوحدة” دون الصراع الذي يثيره ادعاء كل منهما أحقيةَ جني ثمارها، يستدعي بالضرورة سرعة التخلص منهما معًا، واختيار زوج/ حاكم آخر قبل وقوع الحمل، وتكوّن الجنين اليمني الجديد في رحمها، وهو ما لم يحدث، فمضت “الوحدة” في سيناريو الصراع على المولود، والوصول إلى الحرب التي توقعها البردّوني كخطر محدق ب”الوحدة” قبل أشهر من إعلانها، خلال حديثٍ له في نادي الصحفيين بعدن؛ لأن خطواتها المستعجلة أوحت بذلك، فالمقدمات تصنع النتائج.
وقد أدركت “الوحدة”، كشخصية رئيسية في الحوار الذي تكونت منه القصيدة، أنها تمضي دون فرصة لمراجعة خطواتها، ومعرفة مصدر المرارة والحلاوة في جعبتها التي تحملها لعبور الطريق:
واحتثَّني مستقبلي قبل أن أعدّ رمّاني ولا حنظلي
كما إن لبس الزينة والحلي يقتضي وجود اللباس أولًا، لكن “الوحدة” جاءت كمن تعرّى من ثيابه ثم وضع الحلي على جسده العاري، في خروج عن منطق الأشياء:
والآن من بعد التصابي صبا وقام بعد العري كي يحتلي
وبالعودة إلى استقراء مستقبلها، استنطق البردّوني عرافَين شهيرَين في اليمن، هما “الشبيبي” و”العندلي”، فتوصل إلى أخطر نتيجة متوقعة، وهي تشييد بناء “الوحدة” من أجل هدمه وليس إعماره ورعايته:
قال “الشبيبي”: نجمك الثور يا “قرنا” وأبدى شكه “العندلي”
قال اجتلى هاءً ودالاً بلا حاءٍ وواوٍ فاقطعي أو صِلي
فالمنجم “الشبيبي” رأى إمكانية تذكير القرناء (البقرة) بمنحها برج الثور، بينما شكك العندلي بذلك، وقطعها إلى نصفين حسب الحروف المعكوسة لكلمة (وحدة)، ووضع حرفي الهاء والدال (هد) في مقطع، والحرفين الباقيين الذين لا تتم الكلمة إلا بهما (حو) في مقطع منفصل، إذ فصل بين المقطعين بـ”بلا”؛ أي إن فعل الهد المكوّن من حرفي “الوحدة” منطوقة بشكل عكسي، تم بلا احتواء حرفي الحاء والواو لتكتمل الكلمة والفعل معًا (وحدة)، ثم وضع الخيار أمامها أن تقطعهما (انفصال) أو تصلهما (وحدة)، لقد توقع البردوني هدّ بناء المنجز العظيم لحظة ولادته، وهو ما لم يقم به سواه، كاستقراء للآتي من معطيات الحاضر، الذي رآه وعميَ عنه آخرون، ليستطرد في جدليته الحوارية:
أراكِ غيري آخر المنتــــــــهى بدءًا، ونادى من هنا بَسمِلِي
قل: أصبح الشطران بي شطرةً لا بأسَ في جرحَيكِ أن تَرفلِي
كان يفترض بتوحيد الشطرين أن يكون نهاية مسار تم فيه الإعداد الجيد لاستقبال مولود “الوحدة”، لا أن يكون بداية المسار كما حدث، وَفقًا لرأي البردّوني. والبسملة تقال دائمًا في بداية الأمر وليس نهايته، كما جرى معها. وبالتالي وَفقًا لما حدث، فقد أصبح الشطران شطرة أو كعكة يتصارعون لالتهام أكبر قدر منها، بل أصبحا جرحين، بينما من يتغاضى عن وجودهما يدعو “الوحدة” لأن ترفل وتهز جسدها فرحًا رغمهما أو للتغطية عليهما بدلًا من معالجتهما والعمل على التئامهما، فقد تواطأ قادة “الوحدة” الذين تفردوا بها لإظهارها مشوهة وخالية من التعددية التي أعلنتها كمبدأ للحكم:
ومن يرى فردية الجمع في كفّيكِ عهدًا نصف متوكلي؟
فضمن الرؤى المختلفة عنها، هناك من اعتبر التفرد بها من قبل قيادات الجمع الذي ضم حزبي الاشتراكي والمؤتمر، عهدًا “نصف متوكلي”؛ أي إنها قد تتحول إلى ملكية كما كانت اليمن الشمالية في المملكة المتوكلية قبل ثورة 26 سبتمبر/ أيلول 1962، وبالتالي هناك من سيتساءل مستقبلًا عمن اختلى بها، والاختلاء هنا غير شرعي، وإلا لما تساءل أحد عنه:
عشرين عامًا سوف تأتي غدًا ما اسم الذي كان بها مختلي؟
وبالفعل لم يزد عهد الرئيس علي عبدالله صالح، الذي حكم الدولة الوليدة أو “اختلى” بها بتعبير البردوني، عن 21 عامًا بعد تحقيق “الوحدة” بفارق عام واحد عن الـ”عشرين عامًا” التي حددها البردّوني، حتى انتفاضة 2011 التي اعترضت على احتكار الحاكم دولة “الوحدة”، وهو أمر لا يمكن تفسير كيفية التنبؤ به، أو قراءته من قبل البردّوني، بهذه الدقة.
من يرفع صوته لاستعجال “الوحدة” ودعوتها للقفز بما يحمله من مخاطرة، غير حريص عليها، بل يريد إيقاعها في الخطر. بينما الهمس هو نبرة الناصح المحب، فهو يحذرها من أكل الجمر بفمها، وأن يتم أكلها هي لاحقًا بتهمة ارتكبتها أنياب من اقتادها وليس “الوحدة” المنقادة، حيث سيحمّلها البعض خطايا النظام الذي لم يفِ بوعوده التي قدّمها للشعب باسم “الوحدة”، وهو ما حدث فعلًا، وبالتالي كان يجب أن يتنحى وأن تزيحه من طريقها بحزم:
وصائحٌ يدعوكِ أن تقفزي وهامسٌ يوصيك أن تكسلي
محاذراً أن تأكلي الجمر عن أنياب مقتـــــاديك أو تُؤكــلي
تدرين؟ كم قالوا ولم يفعلوا قولي: تنحوا جانبا، وافعلي
بين الصائح والهامس كان هناك أمر غامض أدّى إلى التقاء نصفي اليمن في مرحلة نضج المكر العالمي، الذي فكك دولًا عدة ولم يوحّدها، كما حدث في شرق أوروبا. وبدا أن مصالحَ كبرى لشركات النفط العالمية، رمز إليها اختزالًا بشركة “هنت” الأمريكية، دفعت بها إلى الأمام بتلك الطريقة التي جعلتها تتزوج ضِمدا، كما كانت نساء العرب يفعلن قبل الإسلام، حين تقوم إحداهن بالزواج من رجلين (ضِمد) في الوقت نفسه، وهو ما تساءل البردّوني عنه وتوقعه، وهو أن زوجًا من زوجي “الوحدة” (علي عبدالله صالح، وعلي سالم البيض)، سوف يقوم بخصي الآخر لينفرد بها:
كيف التقى نصفي بنصفي ضحـًى في نضجِ مكرِ العصر يا مأمــــــــــــلي؟
وقـــــال مضنٍ: يا العقـــــــــــــيم التي شاءت مواني “هنت” أن تحبـــــــــــــــلي
يا بنتَ أمِّ الضِّـــــــــــمد قولــــــي لنا: أيّ علـــِيٍّ سوفَ يخصــــــــــــــــي عَلي؟
نتيجة هذه المعطيات الغريبة لولادة الحلم المنتظر لليمنيين، كان هناك غياب هوية في ملامح الدولة/ الحلم الوليدة، فلا هي اشتراكية ولا فلسفتها هيجلية، وعلى افتراض إسلامها لم تبدُ من شكل حكامها قرشيّة ولا من الأبناء (أبناء الفرس من أمهات يمنيات عهد باذان)، ولا من أنصار القومية اليمنية كعبهلة بن كعب (الشهير بالأسود العنسي)، فبدت كـ”عنِين يُزف إلى مشكل”، أي أن كلا الزوجين مصابان باللعنة والازدواج الجنسي فليسوا ذكورًا ولا إناثًا:
لا “رأسماليًّا” أرى ذا الفـــــــــــــتى لا “اشتــــــراكيًّا” ولا “هيجـــــــــــــــلي”
لا في “بني عبدالمدان” اسمه لا من “بني باذان” لا “عبهلي”
وعنــــــــــــــــــــــــــــده زائرة مثـــــــــــــــــــــــله تزف “عنّيـــــــنا” إلى “المشــــــــكل”
كل ما حدث، وَفقًا للبردّوني، هو تغيير في تشكيل الدولة، ليبدو التشكيل الجديد مجرد استقواء من مركز القوى المهيمنة التي رمز لها البردّوني بـ”المقولي” نسبة إلى “مَقْوَلة”، وهي قرية في سنحان منطقة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، أما المناطق الأخرى فكانت هدفًا للمستقوي لإخضاعها، ورمز لها البردّوني بـ”الصلوي” نسبة إلى “الصِّلْو”، وهي مديرية بمحافظة تعز، فـ”الوحدة” متذمرة من عدم إحداث التغيير اللازم لتمضي به قدمًا وتحويله إلى مجرد تضليل رسمي انطلى على الشعب المخدوع باسمها:
ما اقتاد تغيير خطاي التــــي صيَّرنَ ما لا ينطلي، ينطــــــــــــــلي
من غيّر التشكيل عن شكله قوّى على “الصلوي” يد “المقولي”
رغم كل هذه الرؤية القاتمة التي لم يقدمها غير البردّوني لمستقبل يوم مشرق عاشه اليمنيون في 22 مايو/ أيار 1990، بأحلام وطموحات لا سقف لها، فقد عاد في ختام قصيدته ليزرع الأمل بوجود بذور “الوحدة” كفكرة في مكنون محبيها، وأنها ستهطل يومًا، ولكن بعد أن يحدث صراعٌ يُحسم لمصلحة طرفٍ بعينه بالقوة، وليس عبر حوار أو حل سياسي. فقد استدعى لذلك رمزية “المهدي” الذي سيظهر آخر الزمان في الأساطير والمرويات الدينية، ليمثل حاملًا لراية “الوحدة”، بعد أن يهزم “الدجّال” الذي ستتحقق هزيمته بناء على تلك الأساطير بشكل مؤكد، عند إسدال الستار على الصراع المستمر بين ثنائية الخير والشر، والحق والباطل، وهذا مؤشر على أهمية “الوحدة” عند “البردّوني” كيمني لم يستطع تجاوز مشاعره وإغفال عاطفته تجاه “الوحدة” اليمنية، رغم ما أبداه من رأي مغاير ومختلف، لم يجرؤ غيره على إعلانه:
أما تساقيــــنا البروق، المدى وآن أن أغلي وأن تهطــــــــــــلي
أن يرفع “المهدي” منك اللواء أو يركض “الدجال” من منزلي
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية