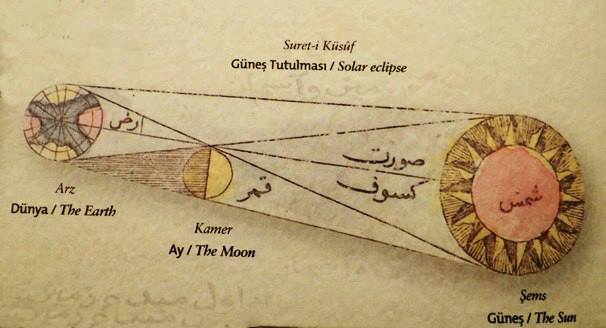الصباح اليمني_ثقافة وهوية|
يعالج موضوعُ تاريخ العلوم عند المسلمين، علمينِ من علوم الأرض: علم الجغرافية الذي يصِفُ سطح الأرض، من حيث الملامحُ الطبيعية، والمناخ، والإنتاج، والشعوب، وتوزيع ذلك كلِّه، وعلم الأرض (= الجيولوجيا)، الذي يتناولَ -من بين ما يتناول- باطنَ الأرض، وتكوُّنَ الجبال، والزلازل والصخور، والرُّسوبيات… إلخ.
لا شك أنَّ ظروفَ الحياة التي عاشها العربيُّ في بلادٍ متراميةِ الأطراف، تكثُر فيها الصحارى الواسعة والبوادي الشاسعة، متنقِّلًا فيها بإبلِه وأغنامه من مكانٍ إلى آخرَ، طلبًا للماء والكَلأ والمرعى، لا شك أنَّ هذه الظروف، دفعت العربيَّ الذي يعيش فيها إلى التعرُّف على معالِمَ ثابتةٍ، وعلاماتٍ دائمة تُمكِّنُه من الانتقال، مستهديًا بها في حلِّه وتَرحاله، ساعده على ذلك السماءُ الصافية فوق بلادِ العرب خلال معظم أيام السنة، بما فيها من نجومٍ ساطعة، وكواكبَ زاهرة، ساعده على الاهتداء بها، فما كان ليضلَّ بعد ذلك في مجاهلِ بواديها، وظلمات صحاريها، وإلى ذلك يُشير القرآن الكريم في قوله -تعالى-: ﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل: 15، 16].
وفي قوله -جل وعلا-: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: 97].
ولا عجب -بالطبع- أن ترسُخَ هذه المعالِم في ذهن ابنِ هذه البلاد الجافية القاحلة، ولا عجبَ -كذلك- أن يدوِّنَها في شِعره الذي يسجِّلُ فيه خواطرَه وخَلَجاتِ قلبِه، ويجعل أسماءَ الأماكن والمواضع تتصدَّر قصائدَه، التي قد تتخلَّلها أسماءُ بعض النجوم والكواكب أيضًا:
أَمِنْ أمِّ أَوْفَى دِمْنَةٌ لَمْ تَكلَّمِ حَومانةِ الدَّرَّاجِ فالمتَثَلَّمِ
ودارٌ لها بالرَّقْمتينِ كأنَّها مَرَاجيعُ وَشمٍ في نواشِرِ مِعْصمِ
• • •
وسهيلٌ كوجنةِ الحِبِّ في اللَّو نِ وقلبِ المُحبِّ في الخَفقَانِ
ضرَّجَتْه دمًا سيوفُ الأعادي فبكَتْ رحمةً له الشِّعْريانِ
لم تقتصر معرفتُه الجغرافية على بلادِه هذه، بل جمع شيئًا من المعلومات الجغرافية عن البلاد المجاورةِ، وبعض البلاد النائية التي وصل إليها عبر رحلاتِه التي كان يقوم بها البعضُ، ومنها رحلتا الشِّتاء والصيف: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: 1 – 4].
فعرَف شيئًا عن الجغرافية الطبيعية والوصفيَّة والاقتصادية لتلك البلادِ بما لا مزيدَ عليه، أفادَتْه هذه المعرفةُ في أمورٍ كثيرة، ولا سيما إِبان الفتوحاتِ الإسلامية الأولى، وما قصةُ الانتقالِ السريع الموفَّق الذي قام به سيفُ الله خالدُ بن الوليد -رضوان الله عليه- وجنودُه من العراق إلى مشارفِ دمشقَ عبر بادية الشام، إلا ثمرة من ثمراتِ المعرفة الجغرافية التي رسَخت في ذهن ذلك العربي، البعيدِ عن المدارس وأماكنِ التعليم.
وإذا كانت معرفةُ العربي الجغرافيةُ محدودةً ومقصورة على بلاد قليلة، فإن معرفتَه في علم الأرض (= الجيولوجية) أقلُّ بكثير؛ فهي لا تعدو إشاراتٍ تتناول الحِرار؛ أي: الأراضيَ البركانية ذات الحجارة السوداء، والزلازل، وبعض الجبال.
وهكذا فإنه يمكن القول: إنَّ المعرفةَ الجغرافية والمعرفة الجيولوجية لم تكن شيئًا يُذكر أمام تلك المعرفة الواسعة الرَّفيعة التي اكتُسبت بعد أن عَمَّ الإسلامُ العبادَ والبلاد.
فلقد كان الإسلامُ بما فيه من تعاليمَ تقتضي معرفةَ جهة القبلة وأوقات الصلوات والصيام والحج… إلخ، أهمَّ عامل في ما حظِيت به المعرفةُ الجغرافية عند المسلمين من توسُّعٍ هائل، فعِلْمُ الجغرافية – كما يذكر المقدسيُّ في مقدمة كتابه: “أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم” – يمثِّلُ بابًا لا بد منه للمسافرين والتجار، ولا غنى عنه للصالحين والأخيار؛ إذ هو علمٌ ترغبُ فيه الملوكُ والكبراء، ويطلبه القضاةُ والفقهاء، وتُحبُّه العامةُ والرؤساء، بل يذهب البيروني – وقد جاء بعد المقدسي بنحو ستين عامًا – إلى أبعدَ من ذلك في أهمية علم الجغرافية والفَلَك معًا، حيث يقول في كتابه: “تحديد نهايات الأماكن”:
“ولو لم يكن بنا حاجةٌ في تحقيق المسافات بين البلدان وحصرِ المعمورة، بحيث يُعرف سمات بعض بلدانها عن بعض – غيرَ الحاجة إلى تصحيحِ القِبلة، لوجب علينا صرفُ العناية إليها، وقصرُ الهمة عليها، فالإسلام قد عمَّ أكثرَ الأرض، وبلغ مُلكه أقصى المشارق والمغارب، وكلٌّ منهم محتاجٌ لإقامة الصلاة، ونشرِ الدعوة إلى القِبلة”.
ومن ثم يذكر البَيروني محاولته تأليفَ كتاب شامل عن الجغرافية، وكيف أنه بدأ بتصحيح المسافات بين البلدان، وتصحيحِ أسمائها، فأنفق في سبيل ذلك أموالاً طائلة لمن سلكوا مختلَف البقاع، ولم يضنَّ عليهم بالمناصب الكبرى، ويذكر -كذلك- أنه عمل نصف كرةٍ من أجل هذا الغرض.
ومن الأمور اللافتة للانتباه أن المسلمين عرفوا -ومنذ وقت مبكِّر- أهميةَ خرائط البلدان والمدن، فاهتموا بها في فتوحاتهم شرقًا وغربًا، ورد في الكامل في التاريخ لابن الأثير (ت 630هـ/ 1233م) أن قتيبةَ بن مسلم الباهلي كتب سنة 89هـ إلى الحجَّاج يُخبره أنه استعصى عليه فتحُ مدينة بخارى، فكتب إليه الحجَّاج يطلب منه أن يصوِّرَها ويبعثَ إليه بصورتها، فلما وصلت الصورةُ إلى الحجَّاج تفرَّس فيها، ثم كتب إلى قتيبة: أنْ تُبْ إلى الله -جل ثناؤه- مما كان منك، وائتِها من مكان كذا وكذا… ففعل قتيبةُ وفُتحت بخارى سنة 90هـ.
بَيْدَ أن اطَّرادَ المعرفة الجغرافية لم يبرز جليًّا إلا عقِب النشاط الهائل الذي بذله بعضُ أهل الخاصة والعامة من المسلمين في نقل الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية، وكان “كتاب السند هند” و”المجسطي” من ضمن الكتب التي تُرجمت إلى العربية.
وكان لكتاب بطليموس “المجسطي”، الذي يمثِّل الاتجاه اليوناني، أثرٌ أعظم في المسار الجغرافي عند المسلمين، من أثر “كتاب السند هند”، الذي يمثِّل المنحى الفارسيَّ الهندي.
وهكذا بدأت دراسةُ الجغرافية علمًا في مطلع القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع الميلادي، وعلى الأخصِّ إبَّان حُكم الخليفة العباسي المأمون (ت 218هـ/ 832م) وبحسَب المدرك اليوناني؛ ذلك لأن المسلمين غدَوا على معرفة تامة ببحوث بطليموس ونظريته الجغرافية القائلة: إنَّ ساحل إفريقية الشرقيَّ يمتد إلى أقصى الشرق.
ولقد وضع الخُوارزمي (ت 232هـ/ 846م) كتابًا في “صورة الأرض” كان على هدَى كتاب بطليموس، جمع فيه الخوارزمي نتائجَ البحوث التي قام بها المسلمون الأوائل، وأظهر فيه جهاتٍ خاصة، منها تقسيم العالَم المسكون إلى سبعِ مناطقَ أو أقاليم، مما لا يوجد في المجسطي، فضلًا عن أنه عالج فيه خطوطَ طول وعَرض الأماكن والجبال والبحار والأنهار وأسماء المدن الواقعة على الجانب المعمور من الأرض، وفي الكتاب عددٌ من الخرائط كذلك.
قال نلِّينو: إنَّ مثل هذا الكتاب لا تقوى على وضعِه أمَّةٌ أوروبية في فجر نهضتِها العلمية.
لقد اتخذ المسلمون في البداءة علماءَ اليونان -ولا سيما بطليموس- أدلاَّءَ لهم في علم الجغرافية، لم يلبثوا -كما يذكر غوستاف لوبون- أن فاقوا أساتذتَهم فيه على حسب عادتهم؛ فقد بدأت الترجمةُ تؤتي ثمارَها بدءًا من النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد؛ إذ كثُر التأليفُ في الجغرافية، وبخاصة الجغرافية الوصفية، بعناوين “المسالك والممالك” و”مسالك الممالك”، و”البلدان”، امتازت هذه الكتبُ بالاستقلال إلى حدٍّ كبير، وبالارتقاء بمستوى الخرائط أيضًا.
بيد أنه ينبغي أن يشارَ هنا إلى أن المسلمين ألَّفوا كتبًا، في وقت مبكِّر في الأنواء والأجواء، تتناول بشكلٍ أو بآخر نواحيَ جغرافيةً، فاقتُضي ذكرُ بعضها؛ لِما لها من صلة بعلم الجغرافية، وكتاب الأنواء لمؤَرّج السدوسي (ت 195هـ/ 810م) يُعَدُّ أقدمَ هذه الكتب، يليه كتاب النَّضْر بن شُميل (203هـ/ 818م)، وغيره كثير…
أما في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، فقد حصل تقدُّمٌ عظيم في بحوث مدرسة الجغرافيِّين المسلمين، كان من شأنه أن خلَّف أعمقَ الأثر في كتب المسلمين الجغرافية وآرائهم، تمتاز الكتبُ التي صنِّفت خلال هذه المدة بمعالجةٍ دقيقة منظَّمةٍ للأمور الجغرافية، وتبسيطِها بالخرائط المفسِّرة، مما يطلق عليه اسم “الوصف”.
وقد برز -بالطبع- عددٌ كبير من المؤلِّفين الجغرافيين المسلمين، تميزوا بنزعةٍ قوية إلى التنقُّل والتَّرحال وجمع المعلومات، نزعة تكشف -كما يقول ألدوميلي- عن مَلَكة التطلُّع القوية عند العلماء المسلمين.
وما كان هذا التقدُّمُ العظيم في علم الجغرافية بخاصة، وفي العلوم الأخرى بعامة، ما كان ليكونَ لولا الأمنُ الذي انتشر في ربوع بلاد المسلمين، بفضل هذا الدِّين الكريم وما ينطوي عليه من تعاليمَ ساميةٍ، ولولا اتباعُ المنهج القرآنيِّ، الذي ذُكر في مقدِّمة هذا البحث، وخلاصتُه أن على العالِم أن يتثبَّتَ من معلوماته بالملاحظة والمشاهدة والتجرِبة أحيانًا، ثم يستخلصَ النتائج في صورِ حقائقَ علميةٍ جديدة.
والرحلة -بالنسبة للجغرافي- تمثِّلُ العينَ المبصرة في الدراسة الميدانية، بما يكفُلُ حملَ لواء الإضافة والتطوير والتجديد؛ ولهذا قلما وُجِد كاتبٌ في الجغرافية لم يَقُمْ برحلة طويلة عبر البلدان، بل إن بعضهم قضى سنين طويلةً في رحلاته؛ فالمسعودي (ت 346هـ/ 957م) -على سبيل المثال- قضى خمسًا وعشرين سنة من حياته في الطواف في مملكة الخلفاء الواسعة، وفي الممالكِ المجاورة لها كبلاد الهند، فَقَيَّدَ ما شاهده في تآليفِه المهمة التي يُعَدُّ كتاب “مروج الذهب” أشهرَها، يصِفُ فيه -من بين ما يصف- البلدان والجبال والبحار والممالك والدول.
كذلك فعل المقدسي الآنف الذكر، بل إنَّ رحلات ابن حوقل (ت بعد 387هـ/ 977م) استغرقت نَيِّفًا وثلاثين سنة، ومن بعدهم فعَلَ البيروني ذلك، فقد رافق السلطانَ محمود الغَزْنَوي في حملته على الهند.
وتُعَدُّ رحلة ابن جبير الأندلسي (ت 614هـ/ 1217م) من أشهرِ ما عرف من الرحلات التي أُنجزت بعد الإدريسي، ثم رحلة ابن بطوطة المرَّاكشي (ت 777هـ/ 1376م) التي حصلت بعد رحلة ابن جبير بقرنٍ من الزمن، واستغرقت خمسًا وعشرين سنة.
وممن يُذكَر من الرحالة: نور الدين أبو الحسن علي بن موسى بن محمد بن عبدالملك بن سعيد المغربي الغَرناطي الأندلسي (ت 685هـ/ 1286م)، فقد جال في الدِّيار المصرية والعراق والشام، وجمع وصنَّف، وهو صاحب كتاب “المُغرب في حلى المَغرب”، يقع في 15 مجلدًا، توارثت أسرتُه تأليفَه حتى وصل فأكمله.
يكشف هذا الكتابُ عن نموِّ المعلومات الجغرافية عن إفريقية، وهو -كما يقول كرامرز في كتاب “تراث الإسلام”- أقربُ إلى الجغرافية الفلكية؛ نظرًا لدقَّتِه العظيمة في تعيين مواقع الأمصار والمدن الرئيسية تعيينًا جغرافيًّا، ويضيف كرامرز أنَّ هذا الكتابَ كان إلى ما قبل مائة سنة تقريبًا أحسنَ الآثار الجغرافية المعروفة عند العرب بعد الإدريسي.
ولم يَخْفَ هذا الاتجاهُ على المنصفين من علماء الغرب في العصر الحديث؛ إذ أشاد بعضُهم بهذه الرُّوح المنهجية المتميزة، فهذا غليد ما يستر Gildmeister يُشيد بالمقدسي (ت نحو 380هـ/ 990م) صاحب كتاب “أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم” حين يقول: إنَّ المقدسيَّ امتاز عن سائر علماء البلدان بكثرةِ ملاحظاته وسَعةِ نظره.
بل إن سبرنغر Sprenger يذهب إلى القولِ: لَم يتجوَّلْ سائحٌ في البلاد كما تجوَّل المقدسي؛ ولم ينتبِهْ أو يحسن ترتيبَ ما عَلِمَ به مثلُه.
والحق أنَّ المقدسيَّ وغيرَه من العلماء المسلمين المرموقين تقيَّدوا بالمنهج العلمي الرصين الذي رسمَتْه لهم تعاليم الإسلام، وانعكس ذلك على أعمالهم وكتاباتهم.
إن تأثيرَ الإسلام الذي يمكِنُ تلمُّسُه في مدينتنا الحاضرة في هذه النواحي العلمية الجغرافية، يظهرُ لنا في الكثير من المصطلحاتِ ذاتِ الأصل العربي في قاموسَيْ “التجارة وعلم الفلاحة”، وحريٌّ أن يقالَ أخيرًا: إن مؤلِّفي الكتب الجغرافية في العالم الإسلامي، كثيرًا ما ربطوا بين البيئة وبين النَّشاط البشري في البلد المعنيِّ، وهذا أمرٌ مهمٌّ لا يخفى على دارسي الجغرافية وعلم الاجتماع.
خليك معناالمصدر: شبكة الألوكة